Launch your professional website today here
الفارس النبيل كامل التلمساني
في أبريل عام 1986 أقمت معرضي الأول فيما كان يسمى وقتها "قصر ثقافة قصر النيل" بجاردن سيتي، الذي صار اسمه فيما بعد "قصر السينما" بعد توجه وزارة الثقافة لإنشاء قصور ثقافة متخصصة، ويبدو أن النشاط الملحوظ للقصر في هذا المجال ساقه لأن يكون مختصًا بالسينما، إذ قبل افتتاح معرضي بقليل قرأت خبرًا في إحدى الصحف عن دورة في الثقافة السينمائية بالقصر، فتوجهت إلى القصر وسجّلت اسمى للاشتراك بالدورة، وأرسلوا لي خطابًا بالبريد بموعد بداية الدورة وجدول محاضراتها، ووجدتها تتزامن مع معرضي بالقصر، وشجعني أن لي قراءات وشغف لا بأس بهما في السينما، وأذكر أنني شاهدت أفلامًا مهمة بهذه الدورة، منها فيلم "ميلوش فورمان" العظيم "أماديوس" وغيره من الأفلام المهمة، وكان يحاضر بها الأساتذة هاشم النحاس، وكمال رمزي والراحلان الأستاذ أحمد الحضري والأستاذ علي أبو شادي عليهما رحمة الله، وكانت محاضرات الأستاذ هاشم النحاس دائمًا مصحوبة بفيلم يقوم بتحليله والتحاور معنا حوله، حتى جاء يوم عرض لنا فيه فيلما مصريا قديما لم نسمع به من قبل، فيلم "السوق السوداء"، وأخبرنا أن هذا الفيلم لم يكن يعرض منذ إنتاجه عام 1945؛ لأنه كان يعرض دون ترتيب بكرات الفيلم الحقيقي، لذلك صُنِّف كفيلم غامض وغير مترابط، وبلا بداية أو وسط أو نهاية، ولم يتحدث عنه مخرجه أو أبطاله فيما بعد، وفشل عرضه بدور السينما حتى أن الجمهور حطم إحدى دور السينما التي كانت تعرضه، ومخرج الفيلم فنان تشكيلي مصري اسمه كامل التلمساني، هنا شعرت أن حواسي كلها تتضاعف لاستيعاب أكبر قدر ممكن من الفيلم والمحاضرة التالية عليه. (هذا المقال نشرت بمجلة إبداع، عدد أكتوبر 2019)
HESHAM NAWAR'S ARTICLES
Hesham Nawar, Visual artist and critic
10/21/20191 min read
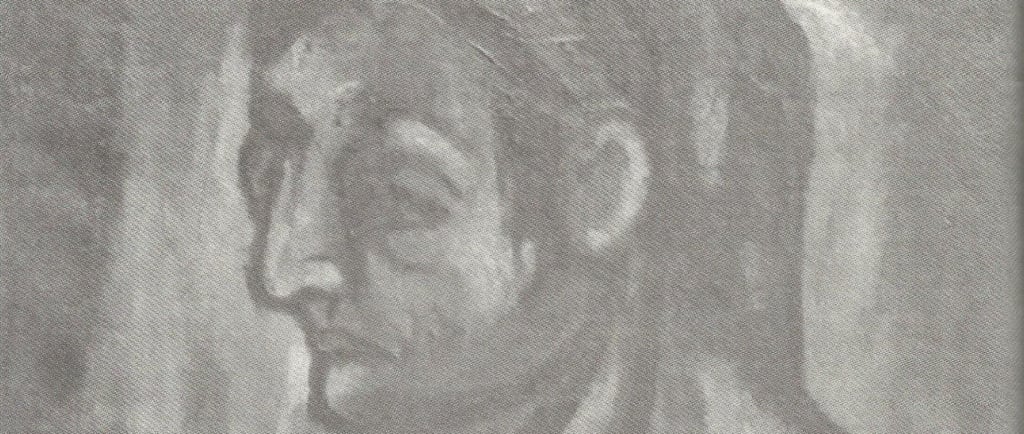

في يناير من العام نفسه صدر كتاب الأستاذ سمير غريب "السريالية في مصر" وقد أثار ضجة كبيرة لما يحويه من كشف وتوثيق لتجربة مهمة من تجارب الإبداع الفني في مصر، فكانت لديَّ بعض معلومات عن كامل التلمساني، وكنت أعلم أنه أخرج عددًا من الأفلام السينمائية، وهذه الأفلام مفقودة، لذلك كانت مشاهدتي لهذا الفيلم تعد حدثًا فريدًا من نوعه، وقد أخبرنا الأستاذ هاشم النحاس أن الذي اكتشف الترتيب الحقيقي للفيلم وطرح عنه أكاذيب الخلل ، هو عامل ماكينة العرض بسينما أوبرا؛ حيث عثر على الفيلم مصادفة بأحد المخازن وشاهده بالترتيب المدون على بكراته وراوده الشعور بأن هناك خطأ ما، وبعد عدة مشاهدات لبكرات الفيلم توصل لترتيبه الحقيقي، وكان ذلك في النصف الأول من الثمانينيات، فكنت سعيدًا أن أكون من أوائل من شاهدوا الفيلم بترتيبه الصحيح، كما شعرت يومها أنني تعرفت حقًا على كامل التلمساني وربما صافحته كتلميذ أو صديق محتمل، لذا توجهت بعد نهاية المحاضرة مباشرة إلى الأستاذ هاشم النحاس ودعوته والحاضرين لمشاهدة معرضي الموجود بقاعة المعارض. بعد خمس سنوات تقريبًا توطدت علاقتي بالأستاذ هاشم النحاس أكثر وتعددت لقاءاتي به إلا أن الغريب في الأمر أنني لم أذكر له أننا التقينا من قبل، ربما تجنبا للخجل الذي يمكن أن يصيبني إذا لم يتذكرني، والحقيقة أنني كنت أشعر أن دعوتي تلك كانت أيضا لروح الفنان كامل التلمساني، وربما يظن البعض من الجنون أو المبالغة أنني كنت أُمني نفسي في أثناء مشاهدتهم للمعرض أن يخرج فجأة من بينهم كامل التلمساني، وأن يتقدم مني ويدعوني للعرض مع جماعته الفنية (الفن والحرية) كما فعل مع تلميذته إنجي أفلاطون (1924 – 1989)، التي كانت في السابعة عشرة حين عرضت أعمالها معهم للمرة الأولى، بينما أنا في التاسعة عشرة حين تعرفت على أعماله وشاهدت فيلمه ودعوته لمعرضي؛ لذلك عندما أقيم معرض للسرياليين المصريين في ديسمبر من العام التالي 1987، بالمركز المصري للتعاون الثقافي الدولي بالزمالك، كانت زياراتي المتعددة له التي ربما كانت بشكل يومي طول فترة المعرض، إنما كانت زيارة لأصدقاء حميمين أأنس بهم وألتمس منهم دفئا يجبر انكسارات وهزائم فنان شاب في مستهل حياته، وأظن أنني مدين للروح التي بثها في نفسي هذا المعرض بالكثير.


ولنعد إلى فيلم "السوق السوداء" مرة أخرى، فبقدر ما بهرني الفيلم وقتها أدهشني أن الفيلم لا علاقة له بالسريالية، بل هو فيلم شديد الواقعية وإن تخللته بعض الأغاني، وربما ذلك فقط ما يجعله يخرج عن إطار الواقع، طبقًا للتصنيف الأكاديمي؛ إذ لا يوجد تعبير بالغناء في الواقع الإنساني الحقيقي، إضافة إلى مشاهد يعلو فيها الحس التعبيري على الواقعي باستخدام الإضاءة أو وضع الكاميرا في موقع يغير من شكل المنظور العادي للصورة، مما يؤدي إلى تكثيف الشحنة التعبيرية للمشهد، لم تدهشني واقعية الفيلم بقدر ما أدهشني أنه لم يكن سرياليًا، وكان جديرًا به حين يقدم فيلمه الأول حاملًا أفكاره السريالية كما فعل العديد من فناني السريالية حين يتوجهون للسينما، ولعل أشهر تلك التجارب فيلم "كلب أندلسي" 1929 الذي اشترك فيه المخرج "لويس بونويل" Luis Buñuel (1900 – 1983) مع الفنان سلفادور دالي Salvador Dalí ( 1904 – 1989). ألم يقرر كامل التلسماني أن يهجر الرسم والتصوير ويتجه إلى السينما لأنها الفن الذي يصل إلى المجتمع بكل طبقاته؟ فكيف لم يقدم فيلمًا سرياليًا يحمل أفكاره التي أحبطها اقتصار مشاهدتها في المعارض الفنية على فئة محدودة من الطبقة الأرستقراطية دون طبقات المجتمع الأخرى، وأظن أن تصنيفه كفنان سريالي هو ما استغله البعض بسوء نية في عرض وتوثيق فيلمه الأول كفيلم غامض وغير مترابط الأحداث، ببساطة لأنه العمل الأول لفنان سريالي قدم لنا فيلمًا سرياليًا، واحتاج الأمر منه ما يقرب من العامين حتى يتجاوز محنة تلك التجربة، ويدرك بذكاء كيف يتجنب الصدام مع قوى يمكن أن تحول دون وصول فنه إلى المجتمع.
عندما نتتبع مسيرة كامل التلمساني عبر رسوماته ولوحاته، نجد أنه ارتبط في بداياته بالكاتب ألبير قصيري الذي بدأ حياته شاعرًا ثم صار كاتب قصة قصيرة، إلى أن استقر أمره روائيًا حتى وفاته عام 2008 في الخامسة والتسعين من عمره، عبر رسومات مصاحبة لقصائد ألبير قصيري الشعرية، ثم كان أن انضما معًا لجماعة "الفن والحرية" ومعرضهم الأول الذي ينشر فيه مانيفستو تأسيس الجماعة الذي كتبه جورج حنين مصحوبًا برسم لكامل التلمساني في عام 1940، غير أنني عبر مسيرته كمصور ورسام لم أجد في أعماله ما يمكن أن يقنعني بأنه كان سرياليًا، مثلما يمكن أن نجد في بعض أعمال شقيقه حسن التلمساني الذي كان عضوًا بالجماعة أيضًا، ففي ظني أن السريالية لم تكن بالنسبة له سوى أيديولوجية فكرية وليست فنية، وإلا فكيف يشاركهم بالعرض مثلا من لا يمكن تصنيفه سرياليًا كما لا ينتمي لجيلهم كالفنان محمود سعيد، بل ويستخدمون صورة لوحة من لوحاته في إحدى مطبوعاتهم وهي لوحة ذات الجدائل الذهبية، لذلك أرى أنه لم يكن بالضرورة للمشاركين بالجماعة أن تكون أعمالهم ذات صبغة سريالية، وإذا كنا نرى ذلك في أعمال إنجي أفلاطون التي شاركت في معارض الجماعة حين كانت في السابعة عشر من عمرها، فهذا راجع في الأغلب إلى انبهارها بالجو الغرائبي في الأعمال السريالية إضافة إلى الأفكار السوداوية التي عادة ما تسيطر على خيالات تلك المرحلة من العمر، لأنها ما أن تنضج فكريًا فيما بعد وتبلغ العشرين من عمرها، نجدها تعتنق الفكر اليساري الماركسي مثل أستاذها كامل التلمساني، لكن هذا يؤدي بها إلى السجن لتقدم بعده وهي في منتصف العشرينيات معرضها الأول بصبغة واقعية تعبيرية وليست سريالية، وتلك ملابسات محيطة بالفنان كامل التلمساني أردت أن أدلل من خلالها أنه لم يكن مضطرًا لأن ينتج لوحات سريالية لارتباطه بجماعة الفن والحرية، وإلا لاختاروا لجماعتهم اسما يتعلق بالسريالية وما كان ليغيب عنهم ذلك مع ما هو مشهود لهم به من اتساع الثقافة. كانت قضيتهم الأساسية الحرية وتجلى ذلك في بيانهم ضد النازية التي وصفت كل التوجهات الفنية الحداثية وقتها بالفن المنحط، لنجدهم يتضامنون مع الفنانين الذين لحقهم ذلك الوصف من قبل سلطة الحكم النازي في ألمانيا والتي وصفت كل الاتجاهات الفنية الحداثية بالانحطاط، بل وأقامت معرضًا قدمت فيه نماذج للفنانين الحداثيين الألمان في تلك الفترة وكان بعنوان "معرض الفن المنحط"؛ فكان عنوان بيانهم، يحيا الفن المنحط، أما إذا تناولنا لوحات كامل التلمساني بالتحليل في جانبيها التقني والفكري، وذلك ما أظنه القول الفصل في ذلك الأمر، فنجده يقوم ببعض المبالغات والتحويرات التشريحية للجسد مع استخدام خطوط سوداء سميكة خشنة لا تخلو من جسارة التحدي لقوانين التصوير الأكاديمية، التي لا تقبل بتلك الخطوط، بل ولا تقبل بوجود اللون الأسود على إطلاقه في اللوحة، لذلك عندما نتذكر استخدام "بيكاسو" للخطوط السوداء في لوحاته لتحديد عناصر اللوحة في تلك الفترة وما قبلها، نجد أن الأمر كان مختلفا بشكل كبير، فالخطوط عند بيكاسو كان دورها جماليًا بالأساس، سعيًا إلى تأكيد انسيابية ورشاقة الأشكال لتبدو خطوطه وكأنها تتراقص فوق سطح اللوحة لتحقيق قدر من الغنائية والشاعرية في أعماله، بينما الخطوط التي يستخدمها التلمساني لتحديد عناصره الفنية في اللوحة ما كانت لتوقعه في أسر جماليات تفرض عليه إظهار مهارات تصويرية تثير دهشة المتلقي، ولنتذكر واحدة من أهم مقولات الفنان "سلفادور دالي" إذ يقول: إنني أقدم فوتوغرافيا من صنع يدي، لذلك من الصعب أن تجد فنانًا سرياليًا لا تبهرك مهارته. تلك الخطوط السوداء الخشنة والألوان البدائية الزاهية لا نجد ما يضاهيها في أعمال التلمساني سوى عند اثنين من أهم فناني التعبيرية في القرن العشرين وهما، "جورج رووه Georges Rouault" (1871 – 1958) وماكس بيكمان Max Beckmann (1884 – 1950) كما كان يشاركهما الجانب الروحاني في أعمالهما، غير أن وجوه شخوصه لا تحمل الفزع والألم الذي في أعمالهما، لأننا إذا نظرنا إلى الجانب الفكري في أعماله الذي يتمثل في موضوعاته، نجد أن ثمة فكرة مسيطرة على غالب لوحاته، لا شك مستوحاة من فكرة الصلب في العقيدة المسيحية، إذ دائما ما نجد أشخاصًا قد اخترقت أجسادهم مساميرعملاقة تمزق أوصالهم، بل وتتمادى فتتجاوز الأيدي والأقدام كما في فكرة الصلب، لنجدها تخترق كل جزء من الجسد، عبر معظم لوحاته المتاحة لنا الآن، فتتجاوز بذلك مفهوم الفداء في الصلب، لأن الألم يلم بالجميع وليس بواحد أو بالبعض.
بالنظر إلى شخصية الفنان كامل التلمساني نجده لم يتخل عن أفكاره ومعتقداته في أي من مراحل عمره القصير، لم يكن يثنيه شيء في دفاعه عن آلام الإنسان البسيط، ولم يكن يغريه مجد زائف، إذ انسحب من جماعة "الفن والحرية" وقت أن كانت في ذروة نجاحها، وكان نجمه ساطعًا وقت أن قرر التوقف عن ممارسة الرسم والتصوير، بعد أن ضاقت به السبل في أن يصل بأعماله إلى من يعبر عنهم، وكما كانت هجرته في عام 1961 من مصر إلى لبنان بعد أن ضاقت به السبل في مصر، كانت هجرته الأولى من اللوحة الزيتية إلى شاشة السينما، والغريب أن توقيت ظهور فيلمه الأول "السوق السوداء"، والذى يعد تدشينا لهجرته تلك كان مواكبًا لهجرة صديقه الأقرب ورفيق دربه ألبير قصيري إلى باريس في عام 1945، فعلى الرغم من عمره القصير إلا أنه دائم التنقل يأبى الاستقرار، إذ انتقل من قريته بمحافظة القليوبية إلى القاهرة ليلتحق بكلية الطب البيطري، ثم يهجرها ليصبح رسامًا مصورًا، ثم يتحول إلى السينما، ثم هجرته إلى لبنان، لكن هجرة كامل التلمساني الأخيرة لم يشاركه فيها أحد، حيث كان في لبنان يعمل مع الأخوين رحباني وفيروز. حتى أن فيروز وقفت تغني والدموع تنهمر من عينيها مع بهجة ما كانت تغنيه، وقفت وظهرها للجمهور لفرط تأثرها، وكان ذلك في الثالث من مارس عام 1972 حين جاءها خبر وفاة الفارس النبيل كامل التلمساني.
المسامير كآدة تعذيب تحدث الألم هي أيضا في حقيقتها أداة لتثبيت الأشياء بعضها ببعض، فما الذي تثبته هنا وتجعله مستمرًا سوى الألم، فهل نرى في ذلك تشاؤمًا وإقرارًا باستمرار هذا الألم؟ في الحقيقة لم يكن ذلك ليخطر بباله، لأنه أراد بذلك أن يظهر الوضع بأسوأ حالاته ليستفز المتلقي للتمرد والثورة على ثبات واستمرار هذا الوضع، لكن هيهات أن يراها كل من كان معنيًا لأنه لا يذهب إلى معارض الفن التشكيلي: كما نلاحظ أيضًا أنه لا يحتفي بمساحات فراغ في اللوحة، مثل تلك التي يحتفي بها معظم السرياليين تعبيرًا عن الوحشة وصدى صراخ الشخصيات، فأي وحشة ووحدة تلك والألم يلم بالجميع، وكما قلت سابقًا أن شخصياته لا تحمل فزع وألم شخصيات "جورج رووه" و"ماكس بيكمان" مع أن ما يحدث لهم شديد الإيلام، كما لا نجد لأجسامهم حركة عنيفة توحي بردة فعل مدمرة كما لدي شخصيات ماكس بيكمان، لكنهم دائمًا وجوه شديدة الوداعة مع حزنها المرير، وكأنها وجوه أيقونات قبطية ذات حزن نبيل، ولا يستطيع ذلك الحزن وما يصاحبه من ألم أن يقمع الإيمان بالخلاص مهما طال عمر الألم وزادت وطأته، وربما تلك الفكرة كانت أشبه بالهاجس المستمر للفنان كامل التلمساني، ففي فترة الحرب العالمية الثانية (1939 – 1945) كان الاقتصاد المصري كله مسخر لاحتياجات الجيش البريطاني على حساب أصحاب البلد، والفقر يعض بأنيابه على أمعاء معظم أفراد الشعب المصري، إلا قليلا من الطبقة الأرستقراطية والتجار الذين استغلوا تلك الظروف ليغنموا الثروات من دم فقراء الشعب، ليفيق التلمساني وقد وجد نفسه يقدم أعمالا عن ألم طبقة من المصريين ليقتنيها طبقة أخرى لا تبالي بألمهم، ما جعله يفكر في السينما كوسيط فني يمكن أن يصل تعبيره من خلاله عن آلام الشعب لأصحاب الألم أنفسهم، لا إلى من لا يعنيهم هذا الألم، بل وربما من يتربح منهم من هذا الألم.
أفيش فيلم "السوق السوداء" إنتاج سنة 1945
إحدى لوحات كامل التلمساني.


